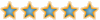ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة شهداء فلسطين |
 |
بكتك العيون يا فارس * وبكتك القلوب يا ابا بسام إدارة ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة ترحب بكم أعضاءً وزوارً في ملتقى الشهيدين محمد وفارس حمودة محمد / فارس ( إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقكم لمحزونون |
|